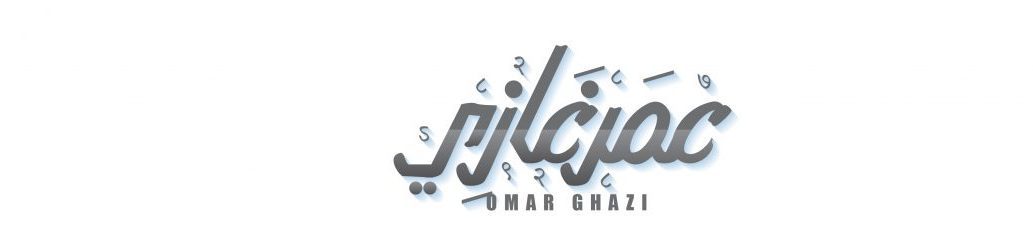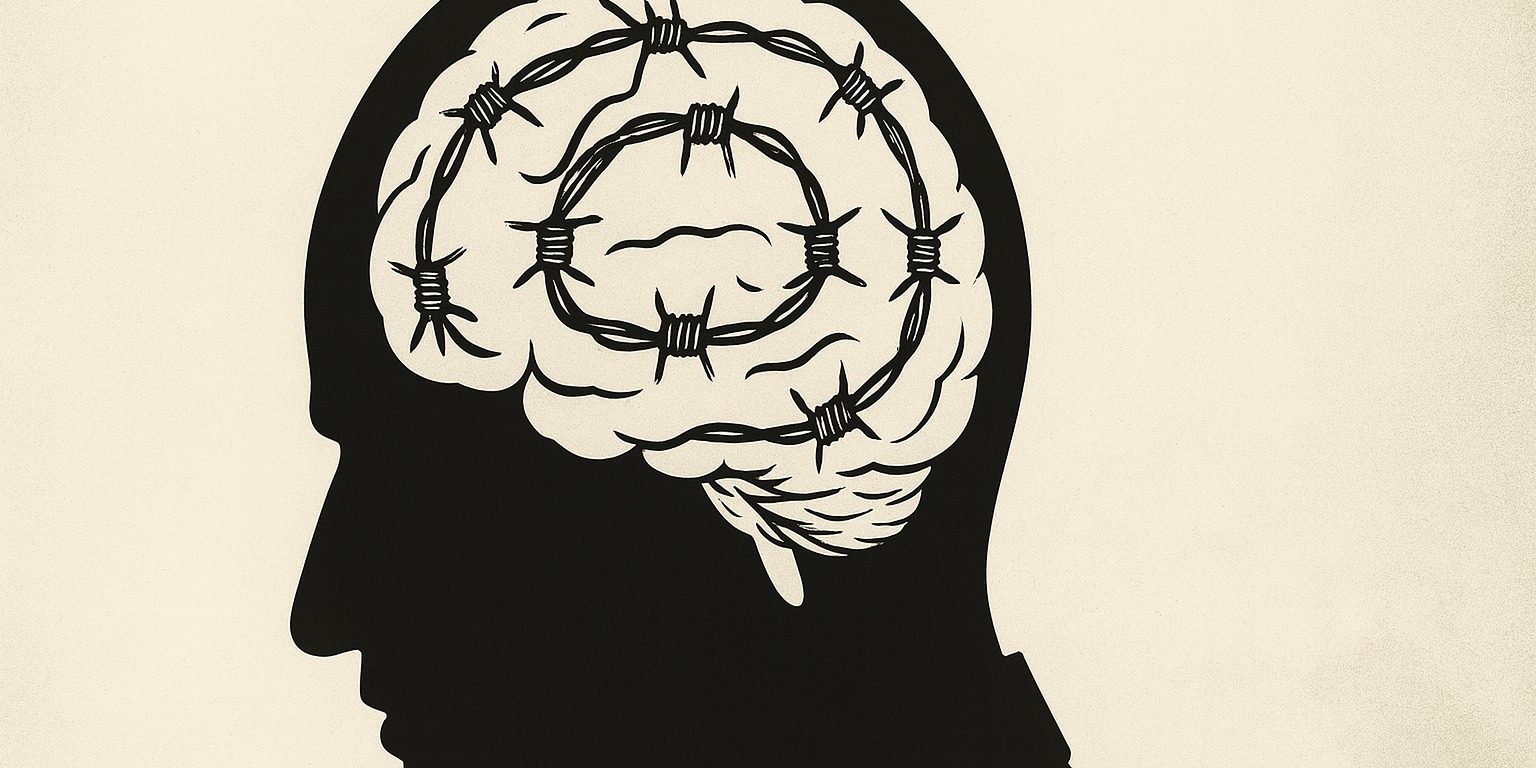عمر غازي
هل يصنع التنظيم عقلًا يشبهه، وهل تتحول الفكرة حين تُحْبَس في هرم مغلق إلى آلةٍ تقرر بدل أن تتفكر، عند هذه العتبة لا يعود السؤال ماذا يريد الإخوان سياسيًا، بل كيف يفكرون حين يقررون، وكيف قادهم نمط التفكير قبل الخطط إلى ما انتهوا إليه في مصر وغزة وسواهما.
جوهر البنية الإخوانية قائم على السمع والطاعة في تراتبية صارمة تُسمى تربية وتنظيمًا، بينما هي في علم النفس الاجتماعي بيئةٌ ترفع الطاعة العمياء وتخفض محاسبة الذات، في جامعة ييل عام 1963 أظهر ستانلي ملغرام أن قرابة 65% من المشاركين امتثلوا لأوامر مؤلمة لمجرد حضور سلطةٍ قريبة وتخفف رقابة الأقران، ثم شرح إرفن جانيس في 1972 في جامعة ييل أيضًا كيف تنزلق الجماعات المتجانسة إلى التفكير الجمعي، وهو نمط يجعل الجماعة تبالغ في الثقة وتزدري التحذير وتفسير المخالف بوصفه ضعف ولاء لا قوة فحص، وهذه السمات تُرى في حلقات البيعة واللجان المغلقة حيث يصبح الانضباط فضيلة تعلو على الاختبار ويتحول نقد القرار إلى قرينة على خلل الإيمان لا إلى شرطٍ لصحة المؤسسة.
الدغمائية هنا ليست شتيمة بل وصفٌ معرفي، الدغمائية أن تُغلَق أبواب المراجعة باسم يقينٍ نهائي وتُكره المنطقة الرمادية وتُطلب إجابة واحدة مهما تعقد الواقع، في جامعة ميريلاند منتصف التسعينيات قدّم أريه كروغلانسكي أبحاث الحاجة إلى الحسم المعرفي التي تُظهر أن كراهية الغموض تدفع إلى قرارات سريعة وتفسير انتقائي للأدلة، وفي جامعة كاليفورنيا بيركلي خلال التسعينيات بيّن فيليب تتلك أن انخفاض التعقيد التركيبي في خطاب القادة يقترن بأخطاء تقدير أعلى ونزعة إلى المواجهة بدل التفاوض، وعندما ننقل هذا إلى عقل الإخوان نرى خطابًا يطمئن الأتباع ببداهات مغلقة ويعادي المراجعة لأنها تهدد الهوية، فينكمش هامش المناورة وتتحول السياسة إلى امتحان ولاء لا إلى اختيارٍ بين بدائل في عالمٍ معقد.
ثم تتغذى مقامرات القرار بوهم القدرة، وهو ما شرحته تالي شروت في كلية لندن الجامعية عام 2011 حيث فسرت كيف يبقي التفاؤل المنحاز توقعات النجاح مرتفعة رغم القرائن العكسية، ويمكننا أيضًا من خلال نظرية الاحتمال عند دانيال كانيمان وعاموس تفيرسكي عام 1979 أن نرى كيف يغامر الناس أكثر حين يشعرون أنهم في منطقة خسارة، وعندما يُترجم هذا إلى تنظيمٍ مغلق تصبح المقامرة في لحظة حصار خيارًا نفسيًا مغريًا لتبديل المعادلة رمزيًا ولو كان الثمن فادحًا، هنا يمكن قراءة اندفاعاتٍ رأيناها في إدارة الحكم بمصر بعد 2012 حيث قُدمت شرعية الشكل على شرعية الأداء وتُركت الدولة العميقة بلا صفقة، وهنا أيضًا يُقرأ تقدير تبعات السابع من أكتوبر 2023 في غزة حيث رُفع المكسب الرمزي فوق حسابات الردع والتحالف والقبول الدولي.
وتصاغ المظلومية بوصفها هوية لا مجرد ملف حقوقي، فالحرمان النسبي الذي قدّمه والتر رونسمان في أكسفورد عام 1966 يشرح كيف يترسخ شعور أنك أقل ولو تحسنت ظروفك قليلًا، والنرجسية الجمعية التي درستها أنجيشكا غولتس دي زفالا في لندن منذ 2009 تبيّن كيف يقتنع الأعضاء بأن جماعتهم أرفع قدرًا مما يتلقونه من اعتبار فيستسهلون تأويل أي نقدٍ عداءً، ومع اجتماع الحرمان النسبي والنرجسية الجمعية تتحول السياسة إلى تعويضٍ وجداني عن الهزيمة، تُفسَّر كل مرونةٍ خيانة، وتُؤطر كل تسوية تنازلًا عن الهوية، فيغلق الباب على المناورة ويستنزف الداخل بالفرز والتخوين.
وللتاريخ شواهده حين تُقرأ بعقل القرار لا بعين المؤامرة، في القاهرة خلال الخمسينيات بدأ ارتهانٌ قصير النظر بتحالفٍ مع جمال عبدالناصر ثم قطيعةٌ قاسية عندما اصطدمت ماكينة الدولة بآلة التنظيم، وفي 2012 بعد الوصول إلى الرئاسة قُدّمت شبكات الولاء على تحالفات الدولة وتُرك المجال العام يُدار بمنطق الدعوة لا بمنطق الدولة فسقطت التجربة سريعًا لأن شرعية الصندوق لم تُسندها شرعية الأداء، وفي غزة بعد انقسام 2007 احتُجز القرار داخل حلقة أيديولوجية تضيقها الجغرافيا وتغذيها المظلومية حتى جاءت عملية السابع من أكتوبر 2023 بكلفةٍ إنسانية وجيوسياسية هائلة، فانكشف مرّة أخرى أثر تقدير المخاطر في جماعة تقيس المكسب بالرمز أكثر مما تقيسه بميزان القدرة والتحالف.
ثمة مفاهيم أخرى تشد الحلقة حين تُهمل المراجعة، التصعيد بالالتزام الذي وصفه باري ستو في بركلي منذ السبعينيات يجعل القادة ينفقون جديدًا دفاعًا عن إنفاقٍ قديم بدل الاعتراف بالخطأ، والتفكير الجمعي الذي عالجه جانيس يفسر لماذا تُسوّق القرارات داخليًا بلا اختبارٍ بديل، والدغمائية التي شرحناها تفسر لماذا يتحول سؤال الجدوى إلى سؤال العقيدة، ومع اجتماع هذه الخيوط تتكرر الأخطاء حتى لو تبدلت الساحات والوجوه.
البديل ليس خلع القيم ولا الانخلاع من الهوية، بل عقلٌ سياسي يقبل الفصل بين الدعوي والمدني، يستبدل الولاء الأعمى بمؤسساتٍ مسؤولة، يرفع منسوب التعقيد في تقدير المخاطر، يحوّل الأذى إلى ملف حقوقي قابل للتفاوض لا إلى قداسةٍ تعطل كل صفقة ممكنة، فالسياسة تُقاس بقدرتها على تحسين شروط الحياة وحماية المجتمع لا بقدرتها على إنتاج قصةٍ مُرضية للأتباع، ومن دون هذا التحول تبقى البنية قيدًا على الفكرة ولو تبدلت الشعارات.
ويبقى السؤال بلا إجابة، هل يمضي الإخوان اليوم نحو انتحارٍ سياسي لا رجعة فيه أم يملكون شجاعة إصلاح عقولهم قبل برامجهم كي يبقوا في السياسة بوصفها فن الممكن لا فن التمجيد؟
الواقع يؤكّد أنّ حبل المشنقة قد أحاط برقابهم في غرفةٍ مغلقة، وأنّ أيَّ حركةٍ—مهما طال الأمد—ستفضي بهم إلى المقصلة.
المصدر: الترند العربي