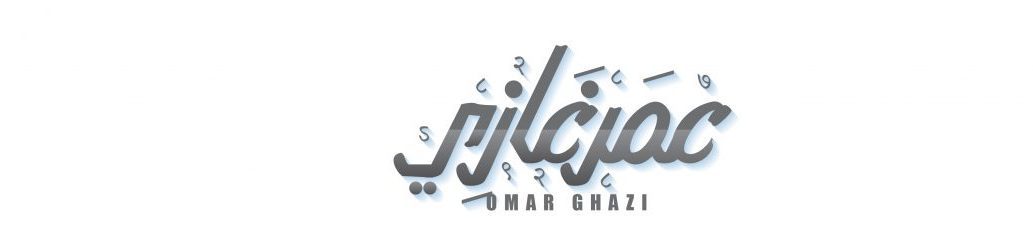عمر غازي
هل يمكن لنعمة أن تثقل صاحبها حتى لا يستمتع بها، وهل يمكن لحرمان أن يحجب الطريق إلى الارتقاء أكثر مما يحجبه العوز ذاته، حين تتحول المقارنة إلى سكن دائم لا عابر تنقلب الثروة قلقًا يطلب برهان المكانة كل صباح، ويتحول الفقر عدسة تصغر الذات وتكبر الغير فتسرق من الإنسان طاقة البناء قبل أن يبدأ.
تقول نظرية المقارنة الاجتماعية التي وضعها ليون فستنغر في خمسينيات القرن العشرين إن الإنسان لا يقيس نفسه بمسطرة مطلقة بل بعيون الجوار، وكلما احتدمت المقارنات صعدت حساسية الترتيب وتقلصت متعة الامتلاك، وقد بين روبرت فرانك في جامعة كورنيل أواخر التسعينيات أن السلع الموضعية التي تشترى لأجل المكانة لا لأجل المنفعة تشعل سباقًا بلا خط نهاية، إذ يبهت الرضا سريعًا لأن قيمة الشيء تقوم على موقعه من الآخرين لا على حاجته الفعلية لصاحبه.
هذا ليس تأملًا لغويًا، فدراسات وايتهول البريطانية بإشراف مايكل مارموت منذ 1967 أظهرت تدرجًا صحيًا يرتبط بالموقع الوظيفي حتى داخل طبقة ميسورة نسبيًا، حيث يتراكم ضغط المكانة ويترجم نفسه في مؤشرات الجسد والسلوك عبر السنين، كما سجل تصوير عصبي نشر في مجلة ساينس عام 2009 بقيادة تاكاهشي أن شعور الحسد ينشط مناطق ألم في القشرة الحزامية الأمامية بينما تنشط دوائر المكافأة عند الشماتة، كأن المقارنة المؤذية لا تجرح المعنى فقط بل تؤذي الجسد أيضًا.
وعند الطرف الأدنى يعمل الحقد الطبقي بوصفه كابحًا للنهوض، فقد قدم والتر رونسمان عام 1966 مفهوم الحرمان النسبي لتفسير كيف يرسخ الشعور المزمن بأنك أقل ولو تحسنت أحوالك قليلًا، وأوضح باحثون في جامعة تيلبورغ عام 2009 الفرق بين حسد حميد يدفع إلى التعلم وتقليد المجتهد وحسد خبيث يدفع إلى التعطيل والانتقاص، وحين يسود النوع الثاني تنصرف الطاقات إلى هدم الصورة أمامنا بدل بناء صورتنا نحن، فتضيع سنوات في سجال رمزي يثبت الطبقات التي كنا نزعم دفعها.
وحين ننظر إلى الحركة بين الطبقات تظهر كلفة المقارنة على المجتمع كله، فقد رسم مايلز كوراك عام 2013 ما عرف بمنحنى غاتسبي العظيم موضحًا أن ارتفاع اللامساواة يقترن بضعف الحراك بين الأجيال، ثم قدرت منظمة التعاون والتنمية عام 2018 أن الانتقال من أسفل السلم إلى وسطه قد يستغرق في الاقتصادات الأشد لامساواة نحو أربعة إلى خمسة أجيال مقابل جيلين تقريبًا في البيئات الأعدل، ليس لأن الفقراء أقل موهبة، بل لأن بيئة المقارنة الصفرية تضعف الثقة والمدرسة والمؤسسات التي تغذي التنقل الاجتماعي.
وللمسافة الاجتماعية أثر آخر على أخلاق العطاء، إذ بين ستيفان كوتيه وزملاؤه في جامعة تورونتو عام 2015 أن ارتفاع اللامساواة يبرد سخاء ذوي الدخل الأعلى بينما يزداد العطاء حين تقل الفجوة ويكثر الاختلاط اليومي، كأن القرب يوقظ التعاطف ويحوله إلى فعل، في حين يجعل البعد السكاني الثروة رقمًا مجردًا لا وجهًا إنسانيًا يطرق الباب.
هكذا يعذب الحقد الطبقي الطرفين معًا، يمنع الأعلى من الاستمتاع بما أوتي لأن الاستمتاع يحتاج أمانًا داخليًا لا يوفره سباق الرموز، ويمنع الأدنى من الارتقاء لأن الارتقاء يحتاج طاقة تصرف إلى المهارة لا إلى مراقبة الغير وتلوين النيات، ويخسر المجتمع حين تهدر الثروة في إظهار دائم لا يبني، وتهدر الهمة في خصومة دائمة لا تنتج، بينما يقاس التقدم الحقيقي بأفعال صغيرة متراكمة لا بضجيج المقارنات الكبيرة.
وليس الدواء شعارًا يطالب الطرفين بالتصالح مع الظلم، بل مسارًا يحول المقارنة إلى مرجعية بناءة لا مرارة معطلة، أن تعرض قصص الصعود باعتبارها مسارات قابلة للتعلم لا لافتات للتمايز، وأن توسع فرص التعليم والعمل بعدالة إجراءات لا بعدالة خطب، وأن يبدل بعض الاستهلاك الرمزي باستثمار ذي أثر عام يخفف توتر السلم الذي نعيش عليه، فالثقة تزداد حين ترى قواعد عادلة وتتضح طرق الارتقاء، وعندها يضعف السؤال من أخذ مني ويقوى السؤال كيف أصل مثله.
ويبقى السؤال، هل نملك شجاعة الانتقال من حرب الرموز إلى هندسة السلم الذي نصعده معًا، أم سنبقى نرهق الأعلى بحراسة المكانة ونقنع الأدنى بأن هدمها انتصار وهو تأجيل جديد لموعد الارتقاء؟
المصدر: الترند العربي